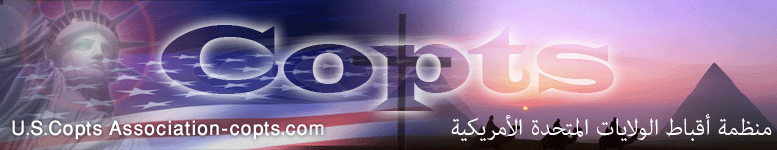
|
|||||||
| المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
 |
|
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
#1
|
||||
|
||||
|
ينشأ الحب بفضل كيمياء سحرية لم يتوصل أحد إلى فك صيغتها السرية حتى الآن. هل هو تفاعل معيّن ينشأ بين شخصين؟ هل هو قطعة مفقودة يجدها الفرد في شخص يعتبره نصفه الآخر؟ أم هو شعور خاص مزروع في قلب كل إنسان؟ مهما يكن الجواب، فإن الحب يخلق دون فعل مسبب له. أي أننا نحب غالباً دون أن يكون هناك فعل محدد وقائم مسبب لهذا الحب ودافعا له. أما الحقد والكراهية فعلى العكس من ذلك، فلا تكون إلا كرد فعل على أذية لحقت بنا. أي أننا نحقد ونكره لأن فعلا معينا قد تم ضدنا، وإساءة ارتكبت بحقنا. وبالتالي نجد فرقا كبيرا بين الاثنين: الحقد هو رد فعل أما الحب فشعور قائم. ومع ذلك حاولت وتحاول الأنظمة والأحزاب الشمولية أن تملي الحب والكراهية إملاء. فهي تقرر عن المواطنين والمحازبين من يجب أن يحبوا ومن يجب أن يكرهوا، وكأن الأمور تتم بضغطة زر. ويتم ذلك عبر إلغاء وحجب آليات التفكير والمحاكمة، واعتبار أن القيادة أدرى بالصالح العام. والأمر ذاته يتم في المنزل حيث يتم تلقين الطفل منذ نعومة أظفاره منظومة متكاملة من التصنيفات للعالم مع ما يمت لها من العواطف. فهو "يجب" أن يحب أشخاصا وأفكارا وأمورا محددة، كما يجب أن يكره أطرافا وعقائد وشعوبا بعينها. وفي لحظة الوعي، التي لا يصلها للأسف الجميع، يصطدم بواقع مغاير لما تم زرعه في فكره ومخيلته. البعض يرتكس ويسأل ويناقش، أما البعض الآخر فينكفئ عائدا إلى الموروث الذي تلقنه موفرا على نفسه عناء البحث والتنقيب. التعصب موجود في كل كائن إنساني وفي كل مجتمع. وكما يمكن تلقين التعصب، يمكن للإنسان أن يتعلم أيضاً كيف يكافحه. في العالم كله لا ينفك التعصب في ازدياد، دينيا كان أم عرقيا. وغزوه للعالم يطرح من جديد التساؤلات حول الانتصارات الحقيقية التي حققتها، ما ندعوه اليوم، بالحضارة الحديثة. وأصبح من الواجب علينا الآن أن نعي مسؤوليتنا الفكرية والأخلاقية تجاه هذه الكارثة. وأن نحدد ما هو الموقف الذي يجب أن نتخذه، وكيف نجابه دوامة العنف الناجمة. أول ما يلفت النظر في التعصب هو غياب اللغة. والتعصب ليس فقط الأداة الرخيصة التي يستعملها العدو، بل هو العدو بذاته. وهو ينفي الثروة المختزنة في اللغة. عندما تفشل اللغة يحل العنف محلها. فالعنف هو لغة الذي لم يعد يعبر عن ذاته بالكلمات. وبالتالي فالعنف هو لغة التعصب الذي يولد الحقد. أما الحقد فهو غير عقلاني. مندفع ولا يتراجع. وقواه الظلامية تنادي كل ما هو مدمّر في الإنسان. نظمه سريع، هدفه مهدِد، وحركته دون رحمة. لا يعرف حدودا أو أسوارا، أعراقا أو ديانات، نظما سياسية أو طبقات اجتماعية. هل يمكن للحقد أن يولد غير الحقد؟ هل يوجد هناك أي شيء ايجابي ونبيل في الحقد؟ وهناك أسئلة أخرى: هل يجب أن نقف موقفا متعصبا تجاه التعصب؟ هل يجب أن نحقد على الحقد حتى نجرده من سلاحه؟ الأجوبة صعبة خاصة في موضوع تختلط فيه العواطف وتحوّره حدثيات غالبا ما تجمّد العقل والمحاكمة. أن نحقد يعني أننا ننكر إنسانية الآخر، ويعني أن نحدد أفقنا عندما ننقص من أفق الآخر. الحقد هو اختيار سهولة اختزال الاحتقار كمصدر للرضى، وهو أن نحفر خندقا سوف يسقط فيه الحاقد وضحيته فيختنقان معا.
__________________
طلبت الى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذنى" (مز 34 : 2-4)[SIGPIC][/SIGPIC] مدونتي كلمة حب |
|
#2
|
||||
|
||||
|
في الدين الحقد يخفي وجه الله، وفي السياسة يدمر الحقد حرية الإنسان. وفي مجال العلوم الحقد يضع نفسه في خدمة الموت. أما في الأدب فالحقد يشوه الحقيقة ويغير من معنى التاريخ، ويغطي حتى الجمال بطبقة كثيفة من الدم والبشاعة. الحقد يتسلل في الكلام كما في النظرات ليحدث اضطرابا في علاقات إنسان مع الآخر، جماعة بشرية مع الأخرى وشعب مع الآخر. التعصب موجود، ويقف في بداية الحقد. إذا لم نوقفه باكرا فات الأوان، لأنّه عندما يبدأ الحقد مسيرته، لا يوجد شيء يمكن أن يوقفه. وعكس الحقد هو أيضا حقد آخر، ولا وسيلة للانتصار عليه غير منعه من أن ينشأ.
لكن هناك حدودا للتسامح، وهناك مرحلة نصل فيها إلى اللا محتمل، ويصبح التسامح مذنبا، ويصبح من الواجب اتخاذ موقف، وإلا حكمنا الشلل، وبقي الباب مفتوحا أمام كل التجاوزات وإلى استقالة الفكر النقدي، وصولا إلى لاعقلانية فكرة تسامح غير محدود. هناك دافعين للتسامح: الدافع الأول هو الشك أو عدم القدرة على اتخاذ قرار أكيد بالنسبة لصواب موضوع أو بطلانه، وبالتالي نتسامح بشأنه. ونادرا ما يكون الدافع يقينا أكيدا، أو قناعة موجودة، من نوع" إني اعرف أن هذا سيء لكن التسامح يجبرني على قبول ما أجده سيئاً".. لكن أين هي الحدود؟ وهل هناك تعصب مبرر؟ وما هي الاعتبارات النفسية، السياسية أو الأخلاقية التي تشرّع لرفضنا التسامح ببعض الأمور؟ للإجابة هناك عدة معطيات: المعطى الأول نفسي يجعل من قبول تسامح غير محدود أمرا صعب القبول، لأن هناك علاقة بين التقييم الأخلاقي والقرار بالفعل، وبالتالي لا يمكن أن نجبر أنفسنا على الامتناع عن المبادرة بشيء نحن على قناعة به. قد يكون من المبرر أخلاقيا أن نقبل بشيء ونتسامح تجاهه مع أننا لا نوافق عليه، لأن هناك قيمة أخلاقية وداخلية بعدم التدخل في أفعال وآراء الآخرين. ولكن عندما يتم تجاوز حد معين فلا يعود من الخير بشيء قبول الشر، والتسامح تجاهه يوازي فداحة ارتكابه. يتأسس التعصب على الثقة من تملك الحقيقة المطلقة وعلى واجب فرضها على الجميع بالقوة، أكان ذلك بأمر إلهي أو بإرادة شعبية. وبالتالي يصبح هذا التعصب مؤسساتيا. وتاريخيا يعود ذلك إلى زمن الهرطقة وإلى المؤسسة الدينية، مسيحية كانت أم إسلامية أم يهودية. وفيها نجد النواة الأولى لكل سياسات التعصب اللاحقة. وهي قادت إلى مفهوم العنف العادل، الذي تمارسه المؤسسة بإرادة شرعية ضد كل شكل من أشكال المعارضة. أما العنف غير العادل فهو في هذه الحالة الذي يستعمله الهراطقة ضد المؤسسة وضد المؤمنين. وهو عنف يجب معاقبته بالإعدام والتعذيب الشنيع. وفي الواقع فإن المعركة من أجل التسامح تم خوضها بدايةً في المجال الديني وذلك منذ القرن السادس عشر. الإنسان هو غريزيا متعصب، وابن خلدون وصفه بأنه حيوان عدواني. ولم يصبح التسامح حقا، غير واضح الحدود والمعالم، وغير معترف به من قبل الجميع، إلا منذ زمن قريب. وتأكّد بالإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان في منتصف القرن الماضي. لقد أدت أهوال الحرب العالمية الثانية إلى ظهور مفهوم التسامح كمبدأ أساسي للتعايش السلمي ضمن التنوع والتعددية.وبعد أن ظهر التسامح كمبدأ عالمي مرتبط بحقوق الإنسان، بقي تلقين الناس مبادئ التسامح وتعلم مفرداته. إن عكس التعصب هو احترام الآخر. أمّا القبول السلبي لكل اختلاف فهو يقود إلى اللا مبالاة ويشجع على التعصب، أي أننا يجب أن نمارس القبول الايجابي ونتفاعل مع الآخر المختلف لا أن ننكر وجوده. تفترض مقاومة التعصب إيجاد تعريف لما هو من غير المقبول التسامح فيه. ضمن الفكر الليبرالي، تُقدم ثلاث حجج لتبرير وضع حد للتسامح: الحجة الأولى وهي الأكثر ذكرا تقول انه لا يمكن أن نتسامح مع ما يهدد التسامح ذاته. فالتسامح فضيلة عكوسة. ولأنها هي ثروة يصبح من الضروري لحمايتها، أن نواجه هجمات الذين يريدون تدميرها. وبالتالي فالأفعال والتصريحات أو التصرفات التي يمكن على المدى القصير أو البعيد أن تشكل خطرا على وجود التسامح، غير مقبولة ولا تحتمل التسامح. أما الحجة الثانية فلها علاقة بموضوع المساس بالحريات ومصالح الأشخاص الآخرين. وعرّف هذا المعيار بشكل جيد جون ستيوارت ميل في مؤلفه "عن الحرية". ويعتبر أنه هناك ثلاث أنواع ن الحريات الأساسية: حرية الفكر، التي يجب أن تكون مطلقة لكل الأفراد، حرية التعبير عن الفكر ونشر الآراء، وحرية العيش بالطريقة التي يرتأيها كل فرد. لكن ممارسة كل نوع من هذه الحريات مشروط بكونه لا يؤذي الآخرين، ويجب عدم التسامح بكل ما يمس هذه الحريات والمصالح. يطرح هذا الشرط إشكالية في حال حرية التعبير. وكمثال على ذلك نأخذ التشهير: في المبدأ يجب أن نرفض ذلك، أما بالواقع فلا يمكن تطبيق ذلك وإلا اضطررنا إلى منع عدد كبير من المنشورات. أي أنه صحيح أن مبدأ عدم إيذاء الآخر قائم وسليم لكن نجد أنفسنا مضطرين في هذه الحالة إلى القبول بأذى قليل خوفا من الوقوع بأذى اكبر وهو تقييد الحريات الشخصية. وهناك عامل آخر يجب أخذه بعين الاعتبار وهو أننا يمكن أن نشعر بالأذى الشديد من قول أو فعل معينين قد لا يكونا بهذه الأهمية بالنسبة للذي ارتكبها ولا يعنيان له الشيء ذاته. الحجة الثالثة بالنسبة لتحديد مفهوم التسامح هي ضرورة الحفاظ على بعض الشروط الأساسية للوجود الاجتماعي المشترك. أي أنه هناك مجموعة من الحقائق الأخلاقية الأساسية تشكل الاتفاق الأخلاقي للمجتمعات الديمقراطية: مثل رفض الإبادة الجماعية، الرق، الاغتصاب، التفرقة العنصرية، العنف ضد الأطفال. وممارسة التسامح يجب أن تتوقف عند هذه الأمراض ولا يمكن أن نقبل أو أن نتسامح مع أي شيء يمت إلى مثل هذه الأفعال بصلة. قال Albert-Ena Caron :"يزدهر التعصب والحقد حيث الجهل والغباء والقومية الكاذبة".
__________________
طلبت الى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذنى" (مز 34 : 2-4)[SIGPIC][/SIGPIC] مدونتي كلمة حب |
|
#3
|
|||
|
|||
|
إقتباس:
لان الاسلام ضلمة عموما بيضلم مخ البنى ادم و يخلى الخفافيش و العناكب تعشش فيه و يخليه جاهل و لما بيبقى جاهل بيخليه متعصب و ما الى ذلك كما يقول الأخ Albert-Ena Caron |
 |
| عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|